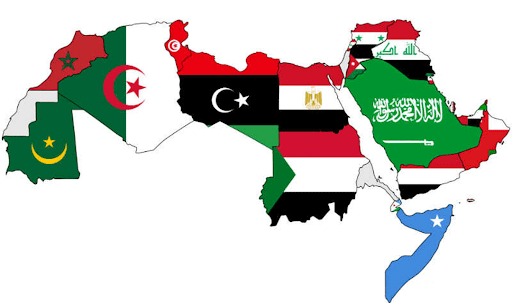متى يرتفع “خطباء الأمة” إلى مستوى المسؤولية القومية؟
موقع قناة الميادين-
أليف صباغ:
عجز بعض الحكام العرب وخوفهم وعبوديتهم المتأصلة تجعلهم لا يرون المتغيرات، ولا يشعرون بالخطر الداهم حتى يصل إلى غرف نومهم.
إجتماعات وزراء خارجية، ومؤتمرات قمة، وخطابات مندوبين وتصريحات ولقاءات على الهامش، ونداءات وتمنيات… إلخ من المفردات التي اعتدناها لعقود سبقت، وبتنا نمقتها، لأنها لم تثمر نتيجة فعلية تستحقها هذه الأمة، بل كل ما ينتج عن هذه “الجهود” يصبّ في مصلحة أعداء الأمة! كيف يحدث كل ذلك ولا تتحرك الشعوب ضد من يدّعي تمثيلها والتخاطب باسمها؟ أهو الإحباط أم الكسل أم التخلف أم ماذا؟
عندما يتحرك المثقف العربي ضد هذه الأنظمة أو ضد حكام الذل والعار، يجد من يسرع ليحذّره من أن البديل الجاهز هو الحركات الإسلاموية، التي أثبتت أنها لا تختلف عن حكام الحاضر إلّا بالأسماء والوجوه، وأشكال التخلف والتبعية للخارج. فلماذا يا ترى لا يجد المثقف القومي سبيلاً لتجنيد الرأي العام العربي والدولي من خلفه؟ لماذا لا يقدّم عملاً فعلياً، وأجندات حضارية وتقدمية تسعى إلى تغيير الحاضر المرير، وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة؟
في الاجتماع الأخير لوزراء الخارجية العرب، عشية الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة، وتمهيداً لاتخاذ موقف عربي موحّد في ما يخص القضايا العربية، طالب وزير الخارجية الفلسطيني، د. رياض المالكي، زملاءه “بالعمل المشترك لحشد الدعم لقرارات دولة فلسطين المزمع تقديمها إلى الجمعية العامة في دورتها الحالية، للحفاظ على زخم القضية الفلسطينية، باعتبارها أولوية على الأجندة الدولية حتى حصول شعبنا على حقوقه كافة، وإنهاء الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي، وتجسيد الاستقلال لدولة فلسطين وعاصمتها القدس.” كلام جميل، لكن ما هو الفعل لتحقيق ذلك؟
كان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، رئيس أكبر دولة عربية، هو أوّل المتحدثين العرب في الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة، فكان خطابه مصر أولاً، وانتهى خطابه بمصر آخِراً، وبين السطور ضمّن السيسي صياغات عربية، خشبية وبائسة، في ما يخص قضية فلسطين، ويا ليت عاد عليها جميعها، بل اختصرها وانتقص منها، بعرض تقديم الخدمات الأمنية من قبل الجيش المصري لحفظ السلام، أي سلام؟! وطالب “المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الأوضاع المعيشية للشعب الفلسطيني”!
بعد كل القمم، الثلاثية وغير الثلاثية، “هذا كل يلّي طِلع معك يا ريّس؟!”. هل تحوّل مطلب تجسيد الحقوق الفلسطينية إلى مجرد “تحسين ظروف”؟! وخدمات أمنية تقدمها مصر “لحفظ السلام”؟ أي سلام؟ وأمْن من؟ إذا كان هذا هو خطاب أكبر دولة عربية، وهي الدولة ذات الحدود المشتركة مع فلسطين، وهي التي تغلق البوابة الوحيدة للفلسطينيين في قطاع غزة، عندما تطلب ذلك دولة الاحتلال، وهي التي تعتقل ناشطي BDS لمقاطعة “إسرائيل” اقتصادياً، فلماذا نستغرب مواقف الدول الأخرى غير العربية، التي تبتعد تدريجياً عن مواقفها السابقة، من تأييد حقوق الشعب الفلسطيني؟
حين يتوجّه الرئيس الفلسطيني في رسالته إلى الرئيس الأميركي جو بايدن، غداة انتخابه، بأنه “مستعد للعمل المشترك معه لتحقيق أمنيات (وليس حقوق) الشعب الفلسطيني”، وحين يقول للصحافيين بعد اجتماع القمة الثلاثية في القاهرة تمهيداً للاجتماع السنوي للجمعية العامة، إن “الاستيطان جعل من المستحيل قيام دولة فلسطينية”، ويقول لشعبه إنه “عاجز عن مقاومة الاحتلال”، فلا يستغربنَّ أحدٌ موقف السيسي، ولا مواقف المغرب والإمارات وقطر والسعودية… ولا يستغربَنّ أحدٌ تراجع الدول الأوروبية عن المشاركة في مؤتمر ديربن لمكافحة العنصرية الصهيونية.
المندوب الإسرائيلي في الأمم المتحدة واحد فقط، وهو غلعاد أردان، مقابل 22 مندوباً عربياً، وعدد كبير من مندوبي “الأمة الإسلامية”، استطاع وحده أن يحقق إنجازاً كبيراً هذه السنة، حتى قبل انعقاد الدورة، بإقناع 31 دولة، بينها أميركا وأستراليا وكندا وغالبية الدول الأوروبية، بما في ذلك اليونان وقبرص وإيطاليا، بإعلان مقاطعتها لمؤتمر ديربن لمكافحة العنصرية الصهيونية. أين كنتم أيها العرب، من مندوبين ووزراء خارجية ورؤساء وملوك وخطباء المنصات الدولية؟ 31 دولة هي أكثر من ضعف الدول التي قاطعت مؤتمر ديربن في الماضي. من المسؤول عن هذا الفشل التاريخي؟
كل المتغيرات الدولية والإقليمية تصبّ في مصلحتنا، وبدلاً من استثمارها نجد حقوقنا في تراجع وتآكل. فهل نسير في حالة عبثية؟
المتغيرات تضج في صيرورتها. العالم لم يعد في قطب واحد، أميركا التي تدعم الاحتلال الإسرائيلي من دون شروط، تفقد مكانتها الدولية. روسيا تستعيد مكانتها، والصين، الصديقة التاريخية، تنهض كالمارد وتتحدى أميركا، تحالفات دولية تنشأ تتحدى أميركا. أميركا تضطر إلى الانسحاب من أفغانستان للتفرغ لقضاياها الداخلية وأزمتها الاقتصادية التي تهدّد عظمتها، كما حصل مع بريطانيا غداة الحرب العالمية الثانية، وهي فرصة لكل الشعوب المظلومة، ولا تعوّض. فهل نفقدها كما فقدنا فرصتنا من ضعف بريطانيا في الماضي؟
إقليمياً، صمدت إيران أمام كل العقوبات الأميركية المتوحشة والتهديدات بالمزيد منها. وسوريا تنتصر على الإرهاب الذي صُدّر إليها من 82 دولة في العالم برعاية الولايات المتحدة وتوجيهاتها. الشعب اليمني الصديق يحقق إنجازات كبيرة على طريق الانتصار الحاسم على التحالف السعودي- الإماراتي، المدعوم من “إسرائيل” وأميركا ودول أخرى. أين نحن من هذه المتغيّرات؟
إن أصل تآكل الحق الفلسطيني ليس في الموقف المصري أو غيره، بل في الموقف الفلسطيني المتخاذل، وهو الذي يعطي للمواقف العربية الرسمية ترخيصاً للتراجع. لقد قدم الشعب الفلسطيني تضحيات جساماً خلال السنة الأخيرة، وأثبت للعالم كله أنه لا يعرف المستحيل، وأن مقاومة الاحتلال وانتزاع الحق الفلسطيني ممكنان. فمعركة “سيف القدس” حققت مفاجأة لم يتوقعها أحد، وأربكت العدو الإسرائيلي، الذي بات يحسب للمقاومة الفلسطينية، عسكرياً وجماهيرياً، ألف حساب. كما أربكت الولايات المتحدة نفسها. وأثبت الأسير الفلسطيني في سجن جلبوع، رغم احتياطات الاحتلال، الذي يستعين بمنظومته الأمنية المدجّجة بالتكنولوجيا، والتي يتفاخر بها أمام العالم، أنه بالعزيمة والإرادة والعمل قادر على أن يحقق المستحيل. هذه الإنجازات الكبرى تحتاج إلى قيادة قادرة ومعنية بأن تستثمرها لتستكمل النصر.
الحكام العرب لا يرون مصالح شعوبهم، فيتحالفون مع من يحمي عروشهم وكروشهم. وبالرغم من التصريحات الأميركية التي تعلن أنها لن تحميهم بعد اليوم، إلا أن عجزهم وخوفهم وعبوديتهم المتأصلة تجعلهم لا يرون المتغيرات، ولا يشعرون بالخطر الداهم حتى يصل إلى غرف نومهم، كما حصل مع حسني مبارك وبن علي. فهل أصبح حكام فلسطين مثل “أشقائهم”؟ أم أصبحت الفصائل الفلسطينية “الحاكم” مثل شقيقاتها، تصنع رموزاً وتعبدها؟ أليست هذه هي الكارثة بعينها؟ وهي تحتاج إلى تحرك عاجل؟!
“القادة” الحقيقيون هم من يقودون التغيير ويخلقون اتجاهات جديدة لمصلحة شعوبهم، أما “الزعماء” فهم من يطلقون ورقة خفيفة كل صباح ليروا اتجاه الرياح، فيسيرون معها. أما الحكام العرب، فيتضح جهاراً أنهم ليسوا قادة ولا حتى زعماء. ربما يرون اتجاهات التغيير، لكن من شدة انغماسهم في العبودية والتبعية لا يجرؤون حتى على السير مع اتجاه الريح. فينطبق عليهم المثل القائل: “لا في العير ولا في النفير”. وقد يكونون في النفير أحياناً ولكنهم متخفّون، وإن تمعنّا في مواقفهم جيداً، نجدهم في الطرف المعادي، يطلقون النار على من خرج من الحظيرة وأعلن حريته وبراءته من القطيع، لأن هذا أصبح يمثّل خطراً عليهم.
المستقبل لمن يعمل، لا لمن ينتظر أو يتبع. المستقبل لمن يقدم للناس برنامجاً بديلاً ويعمل وفق خطة تتضمن أهدافاً قريبة المدى، تكون مقدمات في الطريق إلى تغيير جذري بعيد المدى. المستقبل لمن يعرف كيف ومتى يتنازل لرفاق دربه، ليصل معهم إلى وفاق، لا بد منه، على أدوات ووسائل النضال، ويعي أن طريق الحرية يتطلب استعداداً للتضحية، لا تقل عن تضحيات من سبقونا. بغير ذلك، يبقى المثقف العربي عاجزاً، ولا يختلف عجزه عن عجز حكامه.
على “خطباء الأمة” أن يُدقِّقوا في اختيار صياغات الخطاب، من مفردات وجُمل ومطالب! هذا ليس مستحيلاً.
بما أن القضية المدرجة على جدول أعمال الأمم المتحدة، منذ نشأتها، وقبل ذلك، منذ نشأة عصبة الأمم، هي “قضية فلسطين” لا “القضية الفلسطينية”، وبما أنه لا يوجد “عدل” على هذا الكوكب، بل تسير الأمور، في أفضل الحالات، وفق القانون، وعليه، أيضاً، لا توجد حلول “شاملة”، ولا اقتراحات أو قرارات لحلول “شاملة”، أقترح عليكم استبدال صياغة مطلب “الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية” في خطاباتكم التعيسة بصياغة تقول: إنما نطالب بـ”تطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة لحل قضية فلسطين”، وليس “استنادا” إلى قرارات “الشرعية الدولية”، كما قال الرئيس السيسي.
كما أقترح عليكم أن يعود الرئيس محمود عباس، على علّاته وضعف شرعيته، ليحدّد في خطابه أن الشعب الفلسطيني يطمح إلى تحقيق حقوقه المشروعة، لا “إلى نيل أمنياته”. ربما تعيدنا هذه الصياغات إلى جوهر القضية، وتشير بوضوح إلى من يعطّل تنفيذ قرارات مجلس الأمن، على علّاتها بالنسبة إلينا نحن الفلسطينيين.
مع أن الصياغات وحدها لا تكفي، لا بد من التذكير، في كل خطاب، بأن قرارات مجلس الأمن ظالمة للشعب الفلسطيني، وأن قبوله بها، إنما جاء رغبة في العيش بحرية وكرامة وسيادة واستقلال، وطموحاً للإسهام الفاعل في بناء الحضارة الإنسانية مع كل شعوب الأرض، وبأنه من حق شعبنا، أفراداً وجماعة، أن يستخدم كل الأساليب المتوافرة لديه لتحرير أرضه المحتلة، كما فعلت كل الشعوب الممثلة في الجمعية العمومية، ولا يحق لأحد أن يُنكِر عليه هذا الحق، ما دام المحتل لا يحترم قرارات مجلسكم هذا. مع التذكير، أيضاً، بأن تطبيق قرارات مجلس الأمن، الخاصة بفلسطين، يتطلب انسحاب “إسرائيل” من جميع الأراضي العربية، التي احتلتها بعد اتفاقية الهدنة لعام 1949.
لا تقل لي، أيها القارئ! أصبتَ، أو معك حق… بل قُم واسأل نفسك، ماذا فعلتُ حتى الآن؟ وماذا سأفعلُ اليوم وغداً وبعد غدٍ لتحقيق هذا الهدف؟