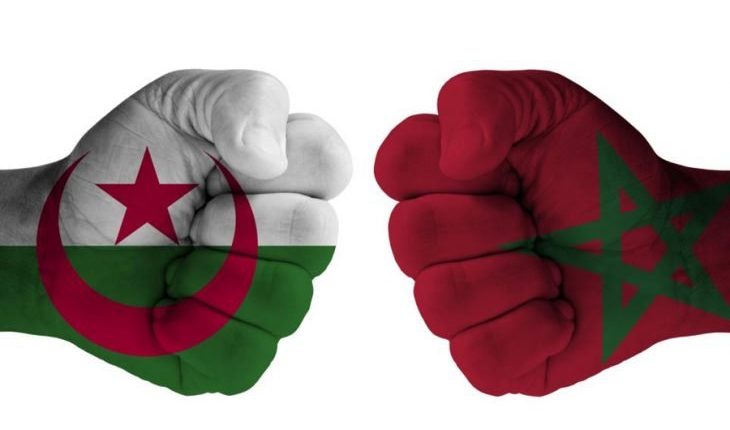خلافات الماضي وأزمات الحاضر.. آفاق العلاقات المغربيّة الجزائريّة
موقع قناة الميادين-
محمد منصور:
إضافة إلى الصراع على صدارة تصدير الغاز في غرب أفريقيا والخلاف حول الصحراء الغربية، يشكّل التقارب بين “تل أبيب” والرباط أحد الأسباب المحورية في توتير العلاقات بين الجزائر والمغرب.
يزخر التاريخ العربي المعاصر بالعديد من القضايا الخلافية التي أدت إلى توتر العلاقات بين دولتين أو أكثر من الدول العربية، لكنَّ العلاقات المغربية – الجزائرية كانت دوماً نموذجاً فريداً، بالنظر إلى عمق ومدى التوتر الذي شاب العلاقات بين البلدين الجارين منذ ستينيات القرن الماضي وحتى الآن.
قرار الجزائر منتصف الشهر الماضي قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب، لم يكن الفصل الافتتاحي في الخلافات بين الجانبين، بل يمكن اعتباره المسار الطبيعي للتوتر المتصاعد بينهما منذ ستينيات القرن الماضي، وخطوة سبق أن اتخذها كلا الجانبين بين العامين 1976 و1988، إذ ظلت العلاقات الدبلوماسية بينهما مقطوعة بشكل كامل طيلة هذه الفترة، حتى توسطت المملكة العربية السعودية من أجل إعادتها مرة أخرى. حينها، كانت هذه المدة – 12 عاماً – هي أطول مدة قُطعت فيها العلاقات الدبلوماسية بين دولتين عربيتين على الإطلاق.
من جانبها، أعلنت الجزائر عدة أسباب لقرارها الأخير بقطع العلاقات مع المغرب، تتنوع بين الجوانب السياسية والأمنية والدبلوماسية، لكن بشكل عام يمكن التركيز على سببين رئيسيين للتوتر المتجذر في العلاقات بين الجزائر والرباط، أحدهما له خلفية تاريخية، والآخر بدأت ملامحه بالظهور بشكل أوضح خلال السنوات الأخيرة.
الصراع على صدارة تصدير الغاز في غرب أفريقيا
نتطرّق أولاً إلى الملف المستحدث في السنوات الأخيرة، وهو ملفّ الصراع المستتر بين الجانبين على ملف تصدير الغاز الطبيعي إلى أوروبا. كان المغرب – رغم العلاقات المتوترة بشكل دائم بينه وبين الجزائر – معبراً رئيسياً لتصدير الغاز الجزائري إلى إسبانيا وأوروبا منذ العام 1997، وخصوصاً أنَّ الجزائر كانت منذ العام 1992 ثاني أكبر مورد للغاز الطبيعي إلى أوروبا بعد الاتحاد الروسي، وذلك عبر تصدير الغاز إلى إسبانيا عبر خط الغاز المغاربي الذي تم تدشينه في أواخر العام 1996 بين الأراضي المغربية والأراضي الإسبانية مروراً بمنطقة جبل طارق. وفي مقابل عبور الغاز الجزائري، تحصل الرباط على كميات منه بأسعار تفضيلية لتشغيل محطتين رئيسيتين لتوليد الكهرباء.
ظل هذا الوضع قائماً منذ سنوات، رغم بعض المحاولات المغربية للتضييق على عمليات التصدير الجزائرية، وهي محاولات ظهرت فعلياً في العام 2014، إذ بدأت بعقد مباحثات مع عدة دول في غرب أفريقيا، من أجل إطلاق خط لنقل الغاز الطبيعي وتصديره، انطلاقاً من دولتي نيجيريا ومالي، مروراً بسبع دول أفريقية أخرى، وصولاً إلى الساحل المغربي.
كان هذا المشروع في الأصل مشروعاً جزائرياً، إذ عرضت الجزائر سابقاً على كلٍّ من مالي ونيجيريا مد خط أنابيب مباشر من أراضيهما نحو الأراضي الجزائرية، ومن ثم ربطه بخط الأنابيب المتجه إلى المغرب، لكن نيجيريا رفضت العرض الجزائري، وهو ما فتح الباب أمام العرض المغربي الذي تم الاتفاق على إطاره الأساسي في العام 2016 خلال زيارة الملك محمد السادس إلى نيجيريا، إذ تم إطلاق الدراسات الفنية الخاصة بتأسيس هذا الخط الذي يتعدى طوله 5 آلاف و500 كيلومتر، وتتجاوز كلفته 121 مليون دولار.
يتألّف هذا الخط من مرحلتين؛ الأولى تقتضي إنشاء رافدين أساسيين؛ الأول قادم من نيجيريا، والآخر قادم من مالي، ويتلاقى كلا الرافدين في غانا بعد مرور الأول على توجو، ومرور الآخر على بوركينا فاسو. المرحلة الأخرى تتضمن مد الخط من غانا على طول الساحل الغربي الأفريقي، مروراً بكل من ساحل العاج وليبيريا وسيراليون وغينيا وغينيا بيساو وغامبيا والسنغال وموريتانيا، وصولاً إلى المغرب.
ظلَّت الجزائر تراهن على أن تبقى فكرة هذا الخطّ نظرية من دون تطبيقها عملياً، وخصوصاً أن هناك عقبات عديدة أمام تنفيذ هذا المشروع، أهمها كلفته القياسية، وكذلك المخاطر الأمنية المتزايدة في منطقة الغرب الأفريقي، والتي تقتضي توفير تأمين كامل ومكلف لهذا الخطّ في كل الدول التي سيمرّ بها، لكن استمرت الرباط في التقدم في هذا الملف، فأطلقت في أيار/مايو 2017 عمليات دراسة الجدوى الاقتصادية الخاصة بهذا المشروع، ثم وقعت في حزيران/يونيو 2018 إعلاناً مشتركاً مع الجانب النيجيري يؤطر الخطوات الفنية اللازمة للبدء بتنفيذه. وقد انتهت نيجيريا في منتصف العام الجاري من الدراسات الخاصة بإنشاء هذا الخط الذي سيكون أغلبه على اليابسة، باستثناء جزء سيتم مده بحرياً.
هذه الخطوة دفعت الجزائر إلى البحث بشكل جدي عن بديل لخط الغاز الذي يمرّ بالأراضي المغربية. وبالفعل، شرعت في العام 2019 في تأسيس خط مباشر بينها وبين إسبانيا، تم افتتاحه بالفعل في أيار/مايو الماضي تحت اسم “ميد غاز”، لكن كان الإعلان النيجيري عن الاستعداد للبدء الفعلي بتنفيذ مشروع الخط الغازي مع المغرب مستفزاً بشكل كبير للسلطات الجزائرية، لأنه يمثل تهديداً صريحاً للاقتصاد الجزائري، إذ تمثل عائدات تصدير المشتقات النفطية والغازية ما نسبته 70% من إجمالي الدخل القومي، ناهيك بأنَّ خط الغاز الجديد سوف يضع دولاً أخرى على خريطة تصدير الغاز إلى أوروبا، ما يهدّد بشكل جدي وضع الجزائر الحالي كمصدر أفريقي أوحد للغاز الطبيعي نحو الشمال.
من هذا المنطلق، يمكن النظر إلى قطع الجزائر العلاقات الدبلوماسية مع المغرب، وتلويح الأولى بعدم تجديد اتفاقية نقل الغاز إلى أوروبا مع المغرب، والتي تنتهي الشهر المقبل، في محاولة للضغط على المغرب الذي سيتأثر بشكل كبير بعدم تجديد هذه الاتفاقية، وخصوصاً أنه يعتمد على الغاز الجزائري في توليد قسم مهم من طاقته الكهربائية، كما أنَّ الغاز الجزائري يمثل النسبة الأكبر من واردات المغرب من الغاز الطبيعي، إذ استوردت الرباط 600 مليون متر مكعب من الغاز الجزائري العام الماضي من إجمالي الواردات المغربية البالغ 750 مليون متر مكعب. هذا الإطار أيضاً يساعد كثيراً في فهم سبب اللهجة المغربية الهادئة في التعاطي مع القرار الجزائري الأخير بقطع العلاقات الدبلوماسية.
الخلاف حول الصحراء الغربية
الملفّ الثاني الذي تسبّب بتدهور العلاقات أكثر بين الجانبين هو ملفّ “الصحراء الغربية” التي تقع غربي المملكة المغربية، والتي مثلت منذ سبعينيات القرن الماضي أحد أهم مسببات التوتر بينهما، نظراً إلى تأييد الجزائر ودعمها جبهة “البوليساريو” الانفصالية التي أعلنت تأسيس ما يُسمى “الجمهورية الصحراوية” في أراضي الصحراء الغربية في العام 1976.
البداية الفعلية لهذا الملفّ كانت – للمفارقة – في المنطقة الحدودية بين المغرب والجزائر، إذ اندلعت مناوشات عسكرية بينهما في تشرين الأول/أكتوبر 1963، سميت باسم “حرب الرمال”، بسبب الخلاف على تبعية منطقتي “تندوف” و”بشار” اللتين تخضعان للسيطرة الجزائرية، واللتين طالب المغرب مراراً بهما.
هذه الحادثة دفعت كلا البلدين إلى التحفز ضد الآخر، في محاولة للبحث عن خاصرته الضعيفة من أجل الضغط عليه. وقد وجدت الجزائر في ملف الصحراء الغربية غايتها، فقد كان هذا الملف من الملفات الأساسية التي اهتم المغرب بها منذ استقلاله عن إسبانيا في العام 1956، نظراً إلى أن عدة مناطق مغربية كانت مستثناة من هذا الاستقلال، ومنها منطقة “أيفني” ومنطقة الصحراء الغربية.
من جانبها، ظلت إسبانيا تحاول الاحتفاظ بمنطقة الصحراء الغربية، نظراً إلى احتوائها مقومات اقتصادية مهمة بين احتياطيات نفطية وغازية محتملة ومعادن متنوعة مثل الفوسفات والمعادن، تمتدّ على مساحة الصحراء التي تبلغ نحو 266 ألف كيلومتر مربع، من ضمنها ساحل يبلغ طوله 1125 كيلومتراً، يحتوي على كميات مهولة من الثروة السمكية.
لهذه الأسباب، أعلنت إسبانيا في العام 1961 تبعية الصحراء الغربية لها، وأسست حينها “الجمعية الصحراوية” التي كان لها ممثل في البرلمان الإسباني. في المقابل، دعمت دول مثل المغرب والجزائر وليبيا محاولات الأطراف المختلفة داخل الصحراء الغربية لمقاومة الاحتلال الإسباني للمنطقة، والتي كانت أبرزها انتفاضة مدينة “العيون” في العام 1970، والتي تسببت لاحقاً بتأسيس “الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب” في العام 1973.
قامت هذه الجبهة بالضغط ميدانياً على السلطات الإسبانية، ما دفع الأخيرة إلى الانسحاب من الصحراء بحلول أواخر العام 1975، إذ سلمت القسم الشمالي منها – المسمّى الساقية الحمراء – للجانب المغربي، في حين سلمت الجزء الجنوبي – المسمى وادي الذهب – لموريتانيا.
الانسحاب الإسباني جاء مترافقاً مع تلويح مدريد بضرورة منح سكان الصحراء الغربية حق تقرير المصير، وهو الاقتراح الذي دعمته الأمم المتحدة، إلا أنَّ العاهل المغربي الراحل الملك الحسن الثاني رفض هذا المبدأ، وقام بالدعوة عبر التلفزيون إلى تنظيم “المسيرة الخضراء” نحو أراضي الصحراء الغربية. وبالفعل، توجه إلى المنطقة في تشرين الثاني/نوفمبر 1975 نحو 350 ألف مغربي، انتشروا في نحو 60% من أراضي الصحراء، وتحديداً النطاق الشمالي والأوسط.
هذه الخطوة صاحبها إعلان جبهة “البوليساريو” قيام “الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية”، وإعلان مدينة “العيون” عاصمة لها، واتخاذ مدينة “تندوف” الجزائرية مقراً للجبهة وحكومتها. لاحقاً، انسحبت موريتانيا من القسم الجنوبي للصحراء في العام 1978، وأصبح هذا النطاق هو مركز نشاط جبهة “البوليساريو” منذ ذلك التوقيت.
تسبّب الدعم الجزائري العلني لجبهة “البوليساريو” واعترافها بالجمهورية الصحراوية التي أعلنتها الجبهة بإقدام المغرب على قطع العلاقات الدبلوماسية بينه وبين الجزائر في آذار/مارس 1976. وشهدت السنوات اللاحقة مواجهات متلاحقة بين الجيش المغربي وجبهة “البوليساريو”، إلى أن تمت إعادة العلاقات الدبلوماسية بين الرباط والجزائر في العام 1988، ثم إعلان وقف إطلاق النار بين المغرب وجبهة “البوليساريو” في أيلول/سبتمبر 1991.
استمر الهدوء بين الجانبين حول هذا الملف حتى آب/أغسطس 1994، حين ثارت ثائرة المغرب بعد تصريحات أدلى بها وزير الدفاع الوطني الجزائري آنذاك – ورئيس الجمهورية لاحقاً – الأمين زروال، قال فيها إنَّ الصحراء الغربية “محتلة”، فقامت الرباط بإغلاق الحدود بينها وبين الجزائر منذ ذلك التوقيت وحتى الآن.
ظلَّ الوضع في الصحراء الغربية على حاله، إلى أن بدأ التوتر بين جبهة “البوليساريو” والمغرب بالتصاعد في آب/أغسطس 2016 حول منطقة “الكركرات” التي تقع في القسم الجنوبي من الصحراء الغربية، على بعد 10 كيلومتر من الحدود مع موريتانيا، والتي تضم معبراً حدودياً بين الجانبين، فقد كانت هذه المنطقة بمثابة نقطة عازلة حدّدتها الأمم المتحدة للفصل بين وحدات الجيش المغربي وقوات “البوليساريو”، إلا أنَّ القوات المغربية قامت باجتياز هذا المعبر، ما أثار اعتراض جبهة “البوليساريو”.
هذه المنطقة كانت سبباً في مشاكل أخرى بين الجانبين، آخرها كان في تشرين الأول/أكتوبر 2020، حين أغلقت جبهة “البوليساريو” المعبر الحدودي مع موريتانيا، ما حدا بالجيش المغربي في الشهر التالي إلى إعادة السيطرة على المعبر بالقوة.
خطوة المغرب أفضت إلى إعلان جبهة “البوليساريو” انتهاء اتفاقية وقف إطلاق النار الموقعة بينها وبينه في العام 1991. هذه الخلاف المتجدد – وإن كان اسمياً بين المغرب و”البوليساريو” – إلا أنَّ الرباط اتهمت الجزائر بأنها وراء إعادة تسخين هذا الملف، وخصوصاً أنَّ الجيش الجزائري قام في كانون الثاني/يناير الماضي بترسيم الحدود بينه وبين “الجمهورية الصحراوية” التي يعترف بقيامها في أراضي الصحراء الغربية.
والجدير بالذكر هنا أنَّ المغرب ارتكز في رده على الخطوات الجزائرية ضده حول ملف الصحراء الغربية باتخاذ خطوات مماثلة حيال ملف منطقة “القبائل” الجزائرية، وهي منطقة تقع شمالي شرق الجزائر، وتضم ولايات “بومرداس – تيزي وزو – بجاية – البويرة – والمديا – جيجل – ميلا”، إلى جانب المناطق الغربية في ولاية “سكيكدة” والمناطق الشمالية في ولايتي “برج بوعريريج” و”سطيف”.
هذه المنطقة شهدت منذ العام 1980 عدة تظاهرات كبيرة لقومية الأمازيغ التي تطالب في جانب من مطالبها بمنح منطقة القبائل الحكم الذاتي، ومنح الأمازيغ امتيازات أكبر ضمن أجهزة الدولة الجزائرية. الرباط أثارت هذا الملف بشكل متكرر على المستوى الدولي، وقدَّمت الدعم لعدة حركات انفصالية داخل منطقة القبائل، على رأسها حركتا “رشاد” و”الماك”.
قامت الرباط بتأكيد موقفها حيال ملف منطقة القبائل في تموز/يوليو الماضي، حين دعا الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، في رسالة إلى حركة عدم الانحياز، إلى منح سكان منطقة القبائل حق تقرير المصير، معتبراً أنها منطقة “محتلة”، وهو ما أثار بالطبع حفيظة الجزائر، وكان من أسباب تصعيد التوتر بين البلدين، وصولاً إلى قطع العلاقات الدبلوماسية. يُضاف إلى ذلك أنّ الجزائر قامت عقب سلسلة الحرائق التي اندلعت في عدة ولايات جزائرية، بالإعلان عن امتلاكها دلائل تؤكد ضلوع حركتي “رشاد” و”الماك” في إشعال هذه الحرائق، وهذا يعتبر اتهاماً ضمنياً للمغرب، نظراً إلى دعمه كلا الحركتين.
“إسرائيل” في خلفية التوتر بين البلدين
إضافةً إلى هذين السببين السالف ذكرهما، يمكن اعتبار التقارب المستمر بين “تل أبيب” والرباط من الأسباب الأخرى المحورية في توتير العلاقات بين الجزائر والمغرب، وخصوصاً بعد التصريحات العالية النبرة التي أدلى بها وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد خلال زيارته الأخيرة إلى المغرب، والتي عبر فيها عن قلقه من “الدور الذي تؤديه الجزائر في المنطقة”، وكذا مخاوفه من التقارب الجزائري مع إيران.
مباعث قلق الجزائر من هذه العلاقة تنبع من أنها تشهد توسعاً في شتى المجالات، وخصوصاً المجال الاستخباري والعسكري، إذ كشفت التحقيقات الجزائرية عن استهداف عدد من المواطنين والمسؤولين الجزائريين عن طريق برنامج “بيغاسوس” الإسرائيلي. يضاف إلى ذلك ما نقله موقع “أفريكان أنتليجنس” عن بحث الرباط و”تل أبيب” التعاون في مجال صنع الطائرات الانتحارية من دون طيار، المعروفة عسكرياً باسم “الذخائر الجوالة”.
التصاعد المستمر في التوتر بين المغرب والجزائر قد يستمر لسنوات قادمة، وخصوصاً في ظل عدم وجود حلول ملموسة لنقاط الخلاف الرئيسية بينهما. ولعل من أهم نتائج هذا التوتر هو الارتفاع القياسي في ميزانية التسليح الخاصة بكلا البلدين، وخصوصاً المغرب، الذي أنفق العام الماضي ما يقارب 5 مليارات دولار على تسليح جيشه، ناهيك بتوسعه بشكل ملحوظ في التعاون العسكري مع تركيا و”إسرائيل” والولايات المتحدة، وهو ما يقابله الجانب الجزائري بمزيد من التسلح والاستنفار، ما يجعل العلاقة بين الجانبين مرشحة للاشتعال في أي لحظة، رغم محاولات عربية خجولة بدأت لتهدئة هذا التوتر الذي قد يزيد من خلط الأوراق في شمال أفريقيا، بالنظر إلى الأوضاع الحالية في ليبيا وتونس.