السادات كان يريد أن يذكره التاريخ بأنه الرجل الذي حسن حياة المصريين
وثائق الاستخبارات الأميركية تبدي قلقا من صعود جماعة الإخوان بعد أن استخدمها الرئيس الراحل ضد التيارات اليسارية
تتضمن وثائق الاستخبارات الأميركية التي أفرج عنها أخيرا وتنشر «الشرق الأوسط» الحلقة الثانية من مقتطفات منها اليوم حول فترة توقيع اتفاقية كامب ديفيد المصرية – الإسرائيلية، تحليلات للشخصيات القيادية المصرية وللأوضاع الداخلية في مصر وتأثير الابتعاد المصري عن الاتحاد السوفياتي السابق على قدرات الجيش، وقدمت بعض الوثائق تحليلا عميقا للتيارات المختلفة داخل المجتمع المصري، وأشارت إلى مخاطر جماعة الإخوان المسلمين وتزايد نفوذها في عهد السادات، كما قدمت تحليلا لشخصية حسني مبارك نائب الرئيس وقتها، والمشير عبد الغني الجمسي وزير الدفاع كأبرز المرشحين لخلافة السادات. وحذرت إحدى الوثائق من تصاعد التوتر السياسي والسخط الشعبي نتيجة تراجع الاقتصاد، وتشير الوثائق إلى قوة وضع السادات وأنه لا يهدده سوى تعرضه إلى محاولة اغتيال أو الإصابة بأزمة قلبية جديدة. كما قالت الوثائق إن السادات بدأ في إثبات قدرته على قراءة مزاج المصريين، وإن اتفاقية كامب ديفيد وجدت شعبية لدى المصريين.. وإلى مقتطفات من هذه الوثائق:
في وثيقة بتاريخ 23 أغسطس (آب) 1978 تصف وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية السادات بأنه ثوري ووطني متحمس جاء من أصول ريفية إلى الحكم بعد وفاة الرئيس جمال عبد الناصر، وكان ينظر إليه باعتباره لا يملك القوة السياسية أو الفطنة السياسية المطلوبة للنجاح لكنه تمكن من تبديد هذه الصورة، وأثبت أنه زعيم معتدل وسياسي ودبلوماسي براغماتي. وعرف بواقعيته وذكائه السياسي وقدرته على اتخاذ قرارات مفاجئة وشجاعة، وهو مستمر في السعي لتحقيق تسوية للسلام مع ثقة وتفاؤل يبدوان واضحين في وجه المخاطر والفشل.
وتحت عنوان «أسلوب القيادة» قالت الوثيقة إن السادات يهيمن على عملية صنع القرار خاصة في مجال السياسة الخارجية، وهو ما ظهر بوضوح في محادثات السلام مع إسرائيل حيث لم يكن مستشارو الرئيس للشؤون الخارجية على يقين بشكل دائم بما يدور بذهن السادات وكان عليهم الرجوع إليه شخصيا في أي قرار. 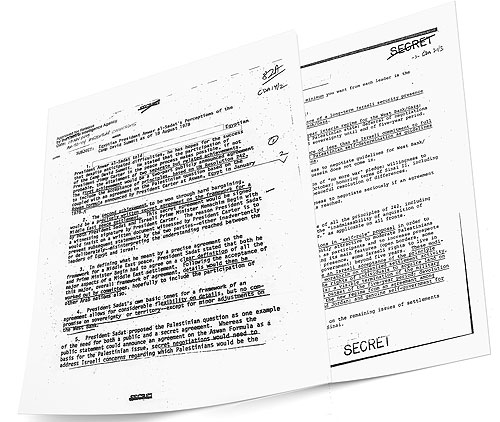
وتضيف الوثيقة (المليئة بالفقرات المشطوبة) أن السادات يتفاخر بأصوله الريفية وحرصه على تلبية احتياجات شعبه، ويريد أن يذكره التاريخ بأنه الرجل الذي قام بتحسين حياة المواطن المصري على المستوى الاقتصادي والاجتماعي. وتشير الوثيقة إلى أن السادات لم يكن لديه الفهم الكافي بالاقتصاد أو الاهتمام بالشؤون الاقتصادية مقارنة باهتمامه بالشؤون السياسية، وأنه عندما يواجه مشكلات تتداخل فيها العوامل السياسية مع الاقتصادية فإن قراره سيكون متأثرا بالعوامل السياسية في أغلب الظن.
أما موشيه ديان وزير الخارجية الإسرائيلي في ذلك الوقت فقدمته الوثائق على أنه أحد الوجوه المعروفة في الساحة السياسية ولعب لسنوات عديدة أدوارا مهمة في حزب العمل الحاكم، وبسبب خلافه ومواقفه المعارضة لتحالف الليكود الذي يقوده رئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم بيغن أصبح أحد الشخصيات المهمة في الدائرة الحكومية الضيقة، ورغم سيطرة بيغن على السياسة الخارجية فإنه يعتمد على ديان في النصائح التكتيكية.
وقد جرى الاستعانة بديان في الحكومة الإسرائيلية بسبب علاقاته القوية بالمجتمعات اليهودية في غرب أوروبا والولايات المتحدة وخبرته الطويلة في التعامل مع الزعماء الأجانب، وبصفة خاصة العرب والأميركيين في قضايا السلام، وتشير الوثيقة إلى دوره البارز كوزير دفاع في حرب 1967 وهو يؤيد عدم الانسحاب ويدعم زيادة المستوطنات في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وفي وثيقة أخرى بتاريخ الأول من يونيو (حزيران) 1976 تحت عنوان «مصر وموقف السادات الداخلي»، تقول الوثيقة إن هذه دراسة أعدت تحت رعاية ضابط بالمخابرات الوطنية في منطقة الشرق الأوسط (شطبت اسمه) إضافة إلى تحليلات وكالة الاستخبارات والأمن القومي ووزارة الخزانة واستخبارات القوات المسلحة. وتشير الوثيقة بوضوح إلى خطورة جماعة الإخوان المسلمين ومخاطر تزايد نفوذها على المدى الطويل بعد أن استخدم السادات التيارات الدينية لمحاربة التيارات اليسارية والشيوعية. وقدمت الوثيقة تحليلا للتحديات التي يواجهها السادات في الجبهة الداخلية.
وتقول الوثيقة إن الرئيس المصري أنور السادات يحكم سيطرته في مصر لكن هناك أسباب للقلق حول قوة موقفه الداخلي ومدى درجة الدعم لقيادته، فمن ناحية يبدو السادات متمتعا بتأييد شعبي، وأكد كبار المسؤولين المصريين قدرة النظام على التعامل مع أي عناصر تخريبية سواء مدنية أو عسكرية، وتبدو المؤسسة العسكرية مخلصة في توفير الدعامة الرئيسة لنظام السادات، لذا فمن الأرجح أن يبقى السادات في السلطة، لكنه ليس بمأمن من تأثير الأنشطة اليسارية وعودة اليمين من جماعة الإخوان المسلمين واستمرار جاذبية الناصرية والميل نحو السوفيات لتوفير موارد مصر من الأسلحة، إضافة إلى تأثير الركود الاقتصادي والضغوط التضخمية على الفقراء في المناطق الحضرية. وإذا تعاونت الدول العربية الصديقة للسادات مع السوفيات في جبهة موحدة ضده، فإن موقفه سوف يهتز بشدة لكن هذا التحالف لن يتمكن من خلعه من السلطة ما دامت القوات المسلحة المصرية تقف وراءه.
وفي الوقت نفسه، فإن السادات يتمتع بشعبية حقيقية ولا يوجد منافس يمكنه الفوز بالدعم الذي ينعم به السادات، وهو يتحكم في الحزب السياسي الوحيد في مصر والبرلمان ولدى أجهزة الأمن لديه سمعة جيدة في ملاحقتها بفاعلية لمدبري أي انقلاب.
وتقول الوثيقة «بخلاف محاولة قتله (السادات) بالرصاص، أو إصابته بأزمة قلبية (ثانية)، فنحن لا نرى أي تهديد للسادات، لكن هناك اتجاهات مثيرة للقلق قد تؤدي إلى مشاكل خطيرة للإقليم».
وتشدد الوثيقة على أن الدور المركزي الذي تلعبه مصر في عملية تحقيق سلام شامل ودائم في الشرق الأوسط يضع أهمية قصوى لاستقرار استمرار نظام الرئيس السادات، وظاهريا تتمتع حكومة السادات بالدعم الداخلي على نطاق واسع وشعبية السادات لا تزال عالية، لكن يواجه النظام معدلات نمو غير كافية وضغوطا تضخمية على الطبقات الدنيا والمتوسطة واحتمالات لظهور مشاكل اقتصادية نتيجة التحرر الاقتصادي والانفتاح. ويواجه النظام أيضا تدهورا عسكريا ناتجا عن تحول السادات عن السوفيات وحركات إحياء الشيوعية، وربما ما هو أكثر مما لا يحمد عقباه على المدى الطويل، وهو عودة ظهور جماعة الإخوان المسلمين اليمينية.
وبالنظر إلى المشهد الداخلي المصري ورغم عدد السكان الكبير نسبيا (نحو 35 مليونا في ذلك الوقت)، فإن نسبة مئوية صغيرة من المصريين لديهم القدرة على التأثير على الأحداث، وهذا يشمل أساتذة الجامعة والمفكرين والبيروقراطيين والسياسيين والعمال والقادة الدينيين، والأهم من ذلك الجيش. أما الأقباط المسيحيون في مصر الذين يتراوح عددهم ما بين أربعة وخمسة ملايين، والفلاحون في دلتا النيل وصعيد مصر الذين يصلون إلى 17 مليونا، والفقراء في المناطق الحضرية (نحو 10 ملايين)، فليس لهم أي تأثير في السلطة السياسية.
وفي الدستور المصري، فإن أهم شيء هو المؤسسة العسكرية التي توفر الأساس لحكم السادات وكانت العربة التي دفعت جمال عبد الناصر إلى السلطة، وهناك بعض المؤسسات السياسية المهمة مثل الاتحاد الاشتراكي وهو الحزب الشرعي الوحيد في مصر، والبيروقراطية المنتفخة، والقادة من الشيوخ المسلمين، والجامعات، ووسائل الإعلام. أما اتحاد العمال والبرلمان فلم يتطورا بشكل كبير ليشكلا نفوذا سياسيا مستقلا، لكن هناك مؤشرات على أن الاثنين (اتحاد العمال والبرلمان) في الطريق للتطور.
وتشير الوثيقة إلى ثقة قادة الأجهزة الأمنية المصرية في السيطرة على أي انشقاق. (وبعد شطب اسم قائد جهاز أمني مصري) تشير الوثيقة إلى تصريحاته بأن الروح المعنوية للقوات المسلحة جيدة، وأن تأثير نقص معدات الغيار للأسلحة جرى التغلب عليه بجهود للحصول على تلك المعدات من مصادر أخرى، ورغم مشاكل الضغوط التضخمية وغلاء المعيشة يشير (القائد الذي جرى شطب اسمه) إلى أن الضباط يعيشون في مستوى اقتصادي أفضل من نظرائهم من المدنيين.
وأكد (قائد آخر جرى شطب اسمه) للسفير الأميركي أن الحكومة حددت بعض المحرضين وأنها تستطيع التعامل معهم، ومع ذلك فإن خطة التقشف لمدة خمس سنوات التي أعلنها السادات في 14 مارس (آذار) قد ينتج عنها بعض الاضطرابات.
وتضيف الوثيقة أنه رغم هذه التأكيدات أن كل شيء على ما يرام، فإن تقارير الاستخبارات في الأشهر الأخيرة تشير إلى مشاكل لا تزال قائمة ورصدت الوثيقة عدة وقائع حول استياء واضطرابات داخل صفوف الجيش والضباط، وتقول «في مارس الماضي واجهت القوات المسلحة مشاكل لوجستية ومشاكل تتعلق بالروح المعنوية (فقرة كبيرة جرى شطبها بأكملها).
وتضيف الوثيقة أن تزايد استياء الضباط بسبب انخفاض إمدادات الأسلحة وإلغاء العلاوات الاستثنائية التي كانوا يحصلون عليها في عهد عبد الناصر وبسبب رحيل الخبراء السوفيات، وأصبح الجيش يواجه مشاكل كبيرة في ما يتعلق بالصيانة لم يحلها الاستعانة بالصينيين واليوغوسلافيين، وأبدى الضباط مخاوفهم من أن تتوقف قدرة الجيش فقط على القيام بدور دفاعي، وقد عكست تقارير أخرى هذا الاستياء بين القوات المسلحة المصرية.
وتقول الوثيقة إنه في 30 مارس كان هناك اضطراب في القوات الجوية، وبين قادة من الجيش في عدد من القواعد لمعارضتهم لسياسات السادات التي عدوها خيانة للقضية العربية، وهناك تقارير تشير إلى تحرك الجيش الثاني والثالث من منطقة القناة، حيث بدأت الاضطرابات من أجل الحيلولة دون انتشار تلك المشاعر المناهضة للنظام.
وفي أبريل (نيسان) (بعد شطب سطرين) كان هناك أعمال شغب في القوات الجوية، وأخرى في الجيش وجرى القبض على 50 ضابطا. وأسباب الشغب ترجع إلى انخفاض الروح المعنوية بسبب إعلان السادات حالة اللاسلم واللاحرب، وتدهور القدرات العسكرية وفشل الجيش في رفع رواتب الضباط لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.
وتضيف الوثيقة أنه لا يمكن تأكيد هذه التقارير حول الاضطرابات في القوات المسلحة، إلا أن المؤكد أن الجيش يواجه المشاكل المتعلقة بالروح المعنوية وأن السادات على بينة من هذه المخاطر وأنه يسعى للحصول على سلاح سوفياتي من دولة ثالثة وأن مخاوفه (كتبها التقرير «فوبيا») من السوفيات مستمرة بلا هوادة.
وتحت عنوان «مخاطر محتملة أخرى»، قالت الوثيقة إنه رغم أن الجيش هو الحامي لنظام السادات فإن عناصر أخرى في المجتمع المصري يمكن أن تزعزع موقفه، ومنها اليمين، فالمجتمع المصري هو مجتمع محافظ ولدى العناصر اليمينية تاريخ قوي، وبصعوبة بالغة تمكن عبد الناصر من قمع الذراع السياسية الرئيسة للمتشددين، وهي جماعة الإخوان المسلمين. ويجب أن نتذكر محاولة التمرد الفاشلة في الأكاديمية الفنية العسكرية بالقاهرة عام 1974 التي قادها متعصب إسلامي حشد الشباب من الطبقة المتوسطة، ويبدو أن نفوذ جماعة الإخوان المسلمين يتزايد أخيرا خاصة في الجيش والحكومة بدعم مالي وأسلحة من ليبيا والهدف على المدى الطويل هو استغلال أوجه القصور من نظام السادات.
وتقول الوثيقة إن جماعة الإخوان استمدت قوتها من عائلات التجار وأصحاب المحال التجارية والفلاحين وأيضا المثقفين، وتهدف إلى الجمع بين الأصولية الإسلامية والنظام السياسي والإصلاحات الاجتماعية الجديدة. وفي مارس الماضي تشكك ضابط أمني كبير في مدى قدرة الجيش على أخذ موقف ضد جماعة الإخوان إذا جرى استدعاء الجيش لقمع أعمال شغب في المناطق السكنية. وقال الضابط الأمني إنه لأول مرة منذ قيام عبد الناصر بإعدام زعماء جماعة الإخوان المسلمين في 1954 أصبح للجماعة رئيس معروف بشكل علني، وهو كمال الدين حسين، وهو نائب الرئيس السابق، وأحد «الضباط الأحرار»، وهي المجموعة التي قادها عبد الناصر للإطاحة بالملك فاروق عام 1952، ويعد كمال الدين حسين الزعيم للجناح العسكري السري لجماعة الإخوان.
وتشير الوثيقة إلى عضو آخر بارز في الجناح العسكري لجماعة الإخوان المسلمين، وهو حسين الشافعي وقد رفض السادات استمرار الشافعي في منصب نائب الرئيس، وطرده منذ عام بشكل غير مشرف، ويمثل كل من الشافعي وكمال الدين حسين أكبر تهديد محتمل لقيادة السادات.
وقد سعى السادات للاستفادة من مخزون المشاعر الإسلامية وشجع الإسلاميين على الصعود لمواجهة النفوذ اليساري بين الطلبة وقادت الحكومة حملة للعودة إلى المبادئ الإسلامية. وأبدت السفارة الأميركية في القاهرة ملاحظات حول اكتساب التيار المتشدد الإسلامي لأرضية واسعة وزيادة الدعم لأفكار «أسلمة» الهيكل القضائي في البلاد. وقالت السفارة الأميركية إن ارتفاع ثقة العناصر الإسلامية بأنفسها كان الثمن الذي دفعته الحكومة لسعيها لاستخدام التيارات الدينية في مكافحة الآراء السياسية اليسارية.
في المقابل، ليس بإمكان اليساريين والشيوعيين والماركسيين القيام بانقلاب وهم يمثلون طبقة مثقفة صغيرة نسبيا بينها عناصر عمالية وطلابية. وتراقب الأجهزة الأمنية المصرية عن كثب الحزب الشيوعي المصري، لكن الماركسيين واليساريين لهم نفوذ مؤثر في وسائل الإعلام وبين طلبة الجامعات. والخطر الرئيس من اليساريين أنهم يستطيعون استنهاض الهمم بين العناصر الموالية للاتحاد السوفياتي في الجيش وبين الطلبة والعمال والفقراء في المناطق الحضرية وبين أفراد الطبقة الوسطى الساخطين. وأحد أهداف اليساريين هو خلق قضايا يتحدون بها مع اليمينيين – الأكثر عددا – في معارضة السادات.
أما الناصريون أتباع جمال عبد الناصر فقد اتهموا السادات بخيانة مبادئ عبد الناصر الخاصة بالوحدة العربية والاشتراكية العربية ويستخدمون اتفاق «سيناء 2» مع إسرائيل كدليل على خيانة السادات للعروبة، ويرون أن انفتاح مصر للاستثمارات الأجنبية الخاصة هو انحراف عن المسار الاشتراكي. وقد جرى ترويض نقابات العمال في مصر منذ عهد عبد الناصر لكن هناك مؤشرات على تحرك قوي في الحركة العمالية التي أصبحت تعاني من الصعوبات الناجمة عن التضخم بعد حرب 1973.
وفي وثيقة تحمل تاريخ الثالث من فبراير (شباط) 1977 بعنوان «تحليل جهاز الاستخبارات لمصر عام 1977»، تشير إلى أن تحقيق تقدم في مفاوضات السلام في الشرق الأوسط سيكون مهما للسادات، لكن الضغوط الداخلية تحد من قدرته على الانتظار طويلا خاصة الوضع الاقتصادي واعتماد القاهرة على الدول المنتجة للنفط في تمويل الفجوة المالية الخارجية الكبيرة والمستمرة. وقد أدى اتجاه الحكومة لتنفيذ إصلاحات اقتصادية تحفز النمو على المدى الطويل إلى زيادة السخط الشعبي واندلاع أعمال الشغب في يناير (كانون الثاني) 1977 مما جعل الحكومة أكثر حذرا في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية. كما أدى انخفاض شحنات الأسلحة السوفياتية لمصر مقابل تزايد المعونات العسكرية لإسرائيل إلى الانتقاص من قدرة مصر على شن حرب ضد إسرائيل بعد حرب أكتوبر (تشرين الأول) 1973 لكن هذا النقص في القدرات العسكرية لا يعني بالضرورة منع مصر جنبا إلى جنب مع الدول العربية الأخرى من القيام بعمل عسكري لتحقيق أهداف سياسية.
وتؤكد الوثيقة أن مخاطر الإطاحة بالسادات (من السلطة) تتزايد إذا لم يكن هناك تحسن في الظروف الاقتصادية أو في مفاوضات السلام، ولذا فإن التطورات خلال عام 1977 ستكون حاسمة ليس فقط لتحقيق الاستقرار الداخلي للسادات، لكن أيضا لتحسين موقف الولايات المتحدة في مصر.
وتضيف الوثيقة «سوف يختبر السادات قدرة الولايات المتحدة على تحقيق تقدم في مفاوضات السلام وعلى استعدادها لمساعدة مصر في الحصول على أسلحة، ومصداقية السادات داخليا تعتمد إلى حد كبير على قدرته على إثبات أن العلاقة مع واشنطن يمكن أن تحقق نتائج ملموسة».
وتحذر الوثيقة أنه إذا لم تتحقق نتائج ملموسة في قضية الأسلحة ومفاوضات السلام خلال شهور قليلة بعد الانتخابات الإسرائيلية في مايو (أيار)، فإنه من المرجح أن يتراجع السادات عن إقامة علاقات وثيقة مع الولايات المتحدة. وذلك لا يعني بالضرورة العودة لإعادة العلاقات مع الاتحاد السوفياتي وإنما يحدث تقارب يسمح بتدفق محدود من الأسلحة، مع إمكانية عالية أن تبدأ مصر وحلفاؤها حربا لإجبار الدبلوماسية على التقدم وليس من المحتمل أن يجري اتخاذ هذه الخطوة خلال عام 1977.
وتشير وثيقة بتاريخ 13 أغسطس 1978 إلى المنافع الاقتصادية التي ستتحقق من تحقيق السلام لكل من مصر وإسرائيل، وتقول الوثيقة إن أي مكاسب في إبرام تسوية سلمية تعتمد على مدى التغير في العقلية لدى كل من مصر وإسرائيل والنظر بشكل أكثر تفاؤلا إلى المستقبل، والفوائد على المدى القصير هي تخفيض عبء الإنفاق العسكري وتحويل الموارد لبناء اقتصاد مدني.
وقالت الوثيقة إن هناك احتمالات كبيرة لحصول إسرائيل على مكافأة اقتصادية لتحقيق السلام، حيث ستؤدي تسوية السلام إلى تخفيف الضغوط على النمو الإسرائيلي وستسهل رفع الإنتاج وزيادة الصادرات الصناعية. وقد قررت تل أبيب تسريح 50 ألف جندي من القوات الإضافية منذ عام 1072 ووفرت تكلفة صيانة هذه القوات لتوجيهها إلى الاستثمار والإعفاءات الضريبية.
وقدرت الوثيقة احتمالات ارتفاع الناتج القومي الإجمالي لإسرائيل بنسبة نصف في المائة سنويا وانتعاش قطاع السياحة مما يساعد على توفير النقد الأجنبي، وقالت الوثيقة إنه بمرور الوقت يمكن لإسرائيل زيادة حصتها في الأسواق العربية حيث تنتج العديد من السلع التي يستوردها العرب من الغرب.
أما مصر، فشددت الوثيقة على أن تحقيق السلام سيسمح لمصر بالتركيز على التنمية الاقتصادية وجعل الاقتصاد أكثر ديناميكية، وقالت إن التسوية لن تترجم فورا إلى مكاسب اقتصادية ضخمة، وإنما ستسرع من التغييرات التي من شأنها أن تسفر عن فوائد كبيرة في المدى المتوسط، والتوصل إلى اتفاق سلام سيؤدي إلى زيادة فرص التنقيب عن النفط في منطقة خليج السويس، وزيادة الاستثمارات الأجنبية والمحلية ونمو قطاع السياحة. وفي نهاية المطاف ستكون القاهرة قادرة على الاستفادة من الخبرة الإسرائيلية في مجال الزراعة الصحراوية وتحقيق الحلم المصري في تحويل الصحراء إلى أراض زراعية.
وفي وثيقة صادرة بتاريخ الأول من سبتمبر (أيلول) 1978، تكشف أجهزة الاستخبارات تفاصيل اجتماع مجلس الأمن القومي الأميركي قبل بدء المفاوضات وقد شارك في الاجتماع الرئيس الأميركي جيمي كارتر ونائبه والتر موندال ومستشار الأمن القومي الأميركي زبغنيو بريجنسكي ووزير الخارجية سايرس فينز ووزير الدفاع هارولد براون ورئيس هيئة الأركان المشتركة هارولد براون وسفير الولايات المتحدة لدى مصر ويليام كوانت وسفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل صموئيل لويس.
وتقول الوثيقة إن الرئيس كارتر سأل عن الشخصيات التي سترافق الرئيس المصري أنور السادات ورئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم بيغن إلى كامب ديفيد، ورد السفير إيلتس بمجلس الأمن القومي أن الفريق حسن التهامي سيرافق السادات، موضحا أنه (التهامي) لا يملك تأثيرا كبيرا على السادات. وأشار إلى أن وزير الخارجية محمد إبراهيم كامل هو الشخص الأكثر أهمية (في التأثير على السادات). وقال إيلتس إن كامل سيحاول حماية السادات من الذهاب إلى مدى بعيد. أما المستشارون على المستوى الوزاري مثل أسامة الباز فسيكون تأثيرهم ضعيفا جدا على السادات، لكن الباز سيكون قادرا جدا على تولي مسؤولية صياغة مسودة الاتفاق.
واستعرض السفير الأميركي لدى إسرائيل الشخصيات الإسرائيلية التي ستصاحب بيغن، ورجح أن يكون لموشيه ديان وزير الخارجية التأثير الأكبر على بيغن، واقترح أن يشارك ديان في الاجتماعات المصغرة مع بيغن، مشيرا إلى علاقة جيدة بين بيغن ووزير الدفاع ويزمان، وإلى علاقة ليست جيدة بين ويزمان وديان.
كما أشار السفير الأميركي لدى إسرائيل إلى اهتمام ديان بالجوانب الأمنية وارتباطه بالأرض في الضفة الغربية وقطاع غزة، وعده عنصرا لضمان الاستمرارية للمفاوضات السابقة، بينما يميل ويزمان للواقعية والإصرار على عدم إضاعة الفرص لتحقيق السلام وهو أكثر اقتناعا بصدق السادات من الآخرين.
وأوضح نائب الرئيس الأميركي أن السادات لا يثق في ديان ويفضل ويزمان. وقدم الأدميرال تيرنر تحليله لعواقب فشل كامب ديفيد، مشيرا إلى أن الفشل لن تكون له عواقب وخيمة على الولايات المتحدة إذا استمر النظر للولايات المتحدة على أنها مستمرة في العمل من أجل التوصل إلى تسوية.
وتقول الوثيقة إن السعوديين يرون أنفسهم في موضع لا يوجد به فشل، وإذا فشلت كامب ديفيد فإن المملكة العربية السعودية ستعمل على جلب السادات إلى الحضن العربي، مشيرة إلى اهتمام السعودية بتحقيق وحدة الدول العربية المعتدلة، وستضغط على السادات ليتصالح مع الرئيس السوري حافظ الأسد، ولديها قلق من الوضع في جنوب اليمن، وإذا رأت المملكة العربية السعودية أن الولايات المتحدة لن تستخدم نفوذها مع إسرائيل فإن (السعودية) قد تتحرك في اتجاه موقف مناهض للولايات المتحدة.
وأضاف الأدميرال تيرنر خلال الاجتماع أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بيغن سيكون سعيدا إذا خرج اجتماع كامب ديفيد من دون نتائج واضحة لأنه لا يريد أن يتحمل اللوم في إفشال المفاوضات من الشعب الإسرائيلي الذي يبدي استعدادا كبيرا لتبادل الأرض مقابل السلام، وأشار إلى أن السوفيات سيحاولون إلقاء اللوم في حال فشل كامب ديفيد على سياسات الولايات المتحدة. وسأل الرئيس كارتر عن موقف الأردن وإذا ما كان يتطلع للسعودية للحصول على إرشادات واستعداد الملك حسين للانضمام إلى المحادثات، وقال الأدميرال تيرنر إن الملك حسين سيحتاج إلى الدعم السعودي وإلى تأكيدات باستعداد إسرائيل للتخلي عن سيادتها على الضفة الغربية، وهذا سيكون أكثر أهمية. بينما حذر مستشار الأمن القومي بريجنسكي من مخاطر كبيرة لفشل كامب ديفيد، وقال إنه يمكن أن يستنتج العرب أن الولايات المتحدة لا تستطيع قيادة عملية السلام وسوف يستخلصون استنتاجات بعيدة المدى حول الدور الأميركي بما يقلل من إحساسهم بالمسؤولية المشتركة معنا بشأن المسائل المتعلقة بالاقتصاد الدولي والنفط، كما ستتزايد قوة التيارات المتشددة. وأبدى بريجنسكي تشككا في القدرة على التنبؤ بتصرفات السادات بعد إشارة الأدميرال تيرنر إلى أن السادات قد يكون مستعدا للمقامرة على حرب أخرى ليس من المتوقع أن يفوز بها مثلما حدث في 1973 عندما ذهب إلى الحرب لإجبار الولايات المتحدة على اتخاذ الإجراءات اللازمة.
كما بحث الاجتماع مسألة الوجود الأميركي في المنطقة، وقال وزير الدفاع الأميركي براون إنه يفضل وجودا أميركيا في سيناء بدلا من حيفا أو الإسكندرية أو الضفة الغربية، موضحا أن الوجود في سيناء أقل خطرا من الوجود في منطقة بحرية، كما طرح فكرة إقامة مؤسسة تدريب جوي في منطقة إيتام، واقترح تزويد إسرائيل بتكنولوجيا التحذير المبكر وإضافة إسرائيل إلى قائمة الدول المعفاة من حدود سقف الأسلحة، وقد عارض بريجنسكي الفكرة.
* ردود فعل مؤيدة للاتفاق في مصر ومرتبكة عربيا
* وفي أعقاب توقيع اتفاقية كامب ديفيد في 17 سبتمبر 1978 رصدت أجهزة الاستخبارات المركزية الأميركية في وثيقة بتاريخ 20 سبتمبر 1978 ردود الفعل في المنطقة العربية تجاه الاتفاقية التي تباينت ما بين الدهشة والارتباك وخليط من ردود الفعل السلبية والإيجابية، وقالت الوثيقة إن القراءات الأولية لرد الفعل لدى الرأي العام المصري والإسرائيلي تشير إلى دعم الأغلبية لما حققه القادة من الجانبين، ورغم ذلك فهناك احتمالات أن يواجه السادات أو بيغن أزمة داخلية.
وقد تلقى بيغن الثناء من أبرز منتقديه، ونال تشجيعا من الأحزاب السياسية الرئيسة، بينما واجه انتقادات شديدة من زعماء اليمين التقليديين، لكن لا يبدو أن تلك الانتقادات ستؤثر على التصويت في الكنيست المقرر الأسبوع المقبل حول إزالة المستوطنات الإسرائيلية في سيناء.
أما ردود الفعل في مصر، فتقول الوثيقة إنه إلى الآن ردود الفعل داعمة لكن صامتة، ورغم تحسن آفاق تحقيق السلام الذي يحتل الصدارة في أذهان معظم المصريين، فإنه جرى ربطه بالانتقادات العربية اللاذعة واحتمالات عزلة مصر عن بقية الدول العربية، كما دفعت استقالة وزير الخارجية محمد إبراهيم كامل إلى التساؤل حول مدى تنازل السادات عن المبادئ العربية.
وقالت الوثيقة على لسان أجهزة الاستخبارات إننا نرى أن هذه التفاعلات الأولية المصرية الإيجابية في عمومها هي مبدئية، ويمكن أن تتغير خلال الأسابيع القادمة بسبب التطورات في إسرائيل أو في العالم العربي. وعلى الرغم من عدم معرفة الكثير من تفاصيل القمة فإن هناك اعترافا واضحا في ما بين الأطراف الرئيسة الأخرى للنزاع في الشرق الأوسط أن اتفاقية كامب ديفيد تمثل نقطة تحول حاسمة ليس فقط لمفاوضات السلام لكن في معادلة القوة في المنطقة.
وتضيف أن رد فعل الأردن الحذر لنداءات الولايات المتحدة للانضمام إلى عملية التفاوض وموافقة سوريا على لقاء وزير الخارجية الأميركي سايرس فينز، يبدو نهجا جديدا. أما التوصيف السلبي للقمة في تصريحات الأردن والسعودية وسوريا فهو بلا شك يعكس خيبة أمل هذه الحكومات في ما أنجزه السادات وقلقهم بشأن استمرار الوجود الإسرائيلي والتعنت بشأن قضايا ذات أهمية خاصة لجمع شمل المعسكر العربي. ومع ذلك فإن ردود الفعل هذه ضرورية باعتبارها موقفا عاما مبدئيا وخطوة أولى في الجولة القادمة من المفاوضات لكن كافة التصريحات منعت تماما إمكانية توسيع المفاوضات.
* قراءة مزاج المصريين
* وفي وثيقة أخرى بتاريخ 25 سبتمبر 1978 حول تطور الوضع العربي – الإسرائيلي بعد اتفاقية كامب ديفيد، أشارت الوثيقة إلى أن السادات بدأ في إثبات قدرته على قراءة مزاج المصريين وخرج مئات الآلاف من المصريين لتحيته عندما عاد إلى مصر. وقد قام المسؤولون الحكوميون وكوادر حزبه بجهود كبيرة للتأكد من إقامة استقبال شعبي كبير للسادات. وأشارت السفارة الأميركية في القاهرة إلى عدم وجود شكوك في حماسة الجماهير الحقيقية بعد الاتفاقية، لكن الحشود رغم ذلك كانت أقل من تلك التي استقبلته بعد عودته من القدس. وقالت الوثيقة إن الشعبية الكبيرة للاتفاق بين الشعب المصري ليست مثيرة للدهشة، ففي الشهور الماضية منذ أطلق السادات مبادرته استغل بمهارة إحساس المصريين بالظلم تجاه الأثرياء العرب والفلسطينيين وإحباطهم الناتج عن كم التضحيات الكبيرة التي قدمها المصريون بالنيابة عن الفلسطينيين.
وأشارت الوثيقة إلى ردود فعل إيجابية لدى القادة العسكريين المصريين ومنهم المشير محمد عبد الغني الجمسي الذي أعلن دعمه الشخصي للاتفاق. ويبدي الجيش المصري قلقا بشأن أن تقود الاتفاقية بالفعل إلى استعادة مصر لسيادتها على سيناء بأكملها بما يبرر التضحيات التي قدمها الجيش.
على الجانب السياسي، قالت الوثيقة إن ردود فعل السياسيين كانت أقل توافقا، فرجال الأعمال وهم الفئة الأكثر استفادة من إحلال السلام كانوا يدعمون بشدة الاتفاقية. وعلى الجانب الآخر أبدى بعض الصحافيين وأساتذة الجامعة والطلبة وبعض الحكوميين تحفظاتهم على الاتفاق، وبعض هؤلاء المتحفظين كانوا داعمين لزيارة السادات إلى القدس، لأنه كان مستمرا في التمسك بالمواقف العربية الأساسية، وهم الآن قلقون من أن السادات أنجز اتفاقا ثنائيا فقط للسلام.
وقالت الوثيقة إن المعارضة المنظمة ضد السادات ستأتي من المصريين اليساريين ومن التيار الإسلامي المتشدد وخرجت بالفعل أصوات يسارية تشكو أن السادات فشل في استعادة السيادة المصرية بشكل حقيقي على سيناء، ومن المتوقع أن يشكو اليمين الإسلامي من فشل السادات في حماية القدس.
وبالنظر إلى المستقبل، فإن أكبر التحديات التي ستواجه السادات ستكون إثبات أن السلام حقيقي، وأنه سيجلب منافع اقتصادية. وقد تعلم المصريون أن يتشككوا في تصريحات أن السلام والرخاء على مسافة قريبة، وألا يتوقعوا تطورا اقتصاديا سريعا بعد الانفتاح الاقتصادي الذي أقدم عليه السادات وسياسة فتح الأبواب التي استفادت منها جماعات صغيرة.ولهذه الأسباب تقول الوثيقة إن السادات لا يمكنه أن يستخف برد الفعل المعاكس لدى السعودية لأن خططه الاقتصادية تعتمد على استمرار التدفق الكبير للمساعدات الأجنبية خاصة بعد إبرام مصر اتفاقية قرض من صندوق النقد الدولي مما يتطلب إجراء إصلاحات في الهيكل الاقتصادي المصري.
وتشير وثيقة صادرة في الرابع من أكتوبر 1978 إلى أن السادات قد يسعى لإعادة تشكيل الحكومة بعد إقالة المشير عبد الغني الجمسي ورئيس الأركان محمد علي فهمي وتعيينهما مستشارين عسكريين للرئيس، وقالت الوثيقة إن الجمسي رغم دعمه لاتفاق السلام لكنه كان لديه تحفظات على بعض سياسات السادات، ووصفت قيام السادات بتغيير اسم الوزارة من الحربية إلى الدفاع بأنه مؤشر إلى عهد جديد.
وقد أقال السادات رئيس الحكومة ممدوح سالم، كما أطاح بأربعة من أقرب مستشاريه من بينهم أشرف مروان ورئيس مجلس الشعب سيد مرعي. وشملت الإجراءات قيام السادات بحملات لإسكات الصحافيين المعارضين وحل الاتحاد الاشتراكي وتأسيس حزب جديد، هو الحزب الوطني. وعدت الوثيقة هذه الإجراءات جزءا من خطة السادات لإعادة تشكيل حكومته وتمهيد الطريق لتطبيق اتفاقية كامب ديفيد.
وقالت وثيقة بتاريخ 9 نوفمبر (تشرين الثاني) 1978 إن حسني مبارك (نائب الرئيس) هو المستفيد الرئيس من التغييرات السياسية التي أجراها السادات، وإن دور مبارك سيكون الإشراف على أداء الحكومة وتطبيق منهج السادات التصحيحي.
مبارك والجمسي أبرز مرشحين لخلافة السادات وفي وثيقة بتاريخ الأول من يونيو 1978 قدمت أجهزة الاستخبارات المركزية الأميركية تقييما للخلفاء المحتملين لخلافة الرئيس السادات، وقالت الوثيقة إن السادات لا يزال يسيطر على الأحداث، لكن الدور المركزي الذي تلعبه مصر في الشرق الأوسط يحتم النظر في عواقب رحيل السادات.
وأضافت أن الاحتمالات عالية لمجيء الموالين للسادات إلى السلطة، ويعد النائب حسني مبارك والمشير عبد الغني الجمسي أبرز المنافسين للمجيء محل السادات وهما يدعمان القواعد الأساسية للسياسة الداخلية والخارجية التي يتبناها السادات ومن المرجح أن يقوما بتغيير بعض التكتيكات المهمة وسيرغبان في وساطة أميركية في المفاوضات مع إسرائيل لكنهما سيريدانها أن تجري ببطء وبالتنسيق مع الحلفاء العرب.
وتقول الوثيقة إنها تفترض أن رحيل السادات لن يستتبعه انهيار لعملية السلام، وأن الموقف تجاه الولايات المتحدة سيعتمد على وضع مفاوضات السلام في الوقت الذي يترك فيه السادات منصبه. وأشارت إلى احتمال أن يسعى الجمسي إذا تولى الحكم إلى إعادة العلاقات المصرية – السوفياتية، لكنها استبعدت محاولات للسيطرة على الحكم بشكل غير قانوني، وقالت إن استيلاء على السلطة يمكن أن يحدث إذا حدثت طفرة كبيرة في السخط على السادات وسياساته تصاحبها اضطرابات مدنية خطيرة.
وأكدت الوثيقة أن الجيش سيلعب دورا محوريا في أي ظرف من الظروف وحذرت الوثيقة أن مجيء حكومة من اليسار المتطرف أو اليمين المتشدد يمكن أن يشكل خطرا كبيرا على عملية السلام.
ووصفت الوثيقة نائب الرئيس حسني مبارك (في ذلك الوقت) بأنه بطل حرب ولا يملك طموحا سياسيا أو خبرة عندما اختاره السادات نائبا له في أبريل 1975، وقد وضعه السادات في خضم اجتماعات كثيرة كانت تهدف إلى إمداده بالخلفية الصلبة من المعلومات حول السياسة الخارجية وكان مبارك بمثابة تجربة في صناعة قائد سياسي، لكن السادات لم يوضح قط ما إذا كان راضيا عن نتائج التجربة (مع مبارك)، لكن من الواضح كما تقول الوثيقة أن مبارك هو خيار السادات كخليفة له إذا كان السادات جادا في مسألة التقاعد. وقد تحدث السادات حول الحاجة إلى قيادات شابة تعكس الثقة التي غرسها نصر أكتوبر. وأشارت الوثيقة إلى غياب ما يدل على نجاح سياسات السادات على الصعيد الداخلي مع تزايد الاستياء من الاضطرابات الداخلية والمشاكل الاقتصادية وسيكون الجيش هو القوة الوحيدة القادرة على إسقاط النظام أو استعادة النظام والحفاظ عليه. وتوقعت الوثيقة أن الجيش يدير مقاليد الأمور في البلاد مع بقاء السادات في السلطة.
* مذكرة حول الاتجاهات في الدول العربية
* تحاول وثيقة بتاريخ 18 فبراير 1976 تحديد الاتجاهات لدى الدول العربية تجاه الولايات المتحدة وآراء العرب حول النزاع العربي – الإسرائيلي، وقامت وكالة الاستخبارات المركزية ووكالة استخبارات الدفاع وممثلون عن الجيش الأميركي والبحرية بإعداد هذه المذكرة من خلال مناقشات مستفيضة مع المسؤولين في سفارات الولايات المتحدة في مصر وسوريا والمملكة العربية السعودية والأردن والجزائر. وتقول الوثيقة إن «الزعماء العرب لديهم قالب فكري جامد في نظرتهم السياسية وبالتالي فهم إما مؤيدون أو مناهضون للولايات المتحدة، واليوم هم أقل عاطفية وأكثر مرونة وأكثر استعدادا للنظر في المزايا المحتملة للتعاون مع الولايات المتحدة، وأدركوا أن الولايات المتحدة تحمل مفاتيح لكثير من أهدافهم المهمة مثل استعادة الأراضي التي تحتلها إسرائيل والحصول على التكنولوجيا لمصاحبة القوة الاقتصادية الجديدة لبلادهم وإيجاد سوق لبيع النفط العربي».
وتضيف الوثيقة أن مدى استعداد أي دولة عربية لإزالة الغمامة الآيديولوجية في نظرتهم للولايات المتحدة يعتمد بدرجة كبيرة على درجة البراغماتية لدى تلك الدولة. وبصفة عامة كلما زاد ميل دولة عربية تجاه مرونة دبلوماسية غير عاطفية زاد استعدادها للتعاون معنا. وعلى العكس من ذلك، فكلما زاد اعتماد الولايات المتحدة على الآيديولوجية ارتفعت الشكوك (لدى الدولة العربية) وتزايد التباعد عن الاتصال مع واشنطن. وقد اعتمدت بعض الدول العربية نهجا أكثر مرونة في السياسة الخارجية وتجاه الولايات المتحدة لكن لديهم مواقف مترددة تجاه الولايات المتحدة، فهم يريدون التعاون من جانب وفي الجانب الآخر لديهم شكوك آيديولوجية تمنع التعاون. وترتكز مواقف الدول العربية تجاه الولايات المتحدة على قياس تصوراتهم حول لماذا تدعم الولايات المتحدة إسرائيل ومدى فهمهم للعملية السياسية في الولايات المتحدة وآثارها المحتملة على السياسة الخارجية الأميركية. وكقاعدة عامة، فدول عربية مثل مصر التي لديها اتصالات مكثفة مع الولايات المتحدة تميل إلى أن تكون أكثر تسامحا تجاه العلاقة الخاصة بين الولايات المتحدة وإسرائيل والاعتراف بأن المساعدات الأميركية هي التي تمكن الولايات المتحدة من الضغط على إسرائيل لتقديم تنازلات، والمصريون أكثر تفهما للصعوبات التي تواجهها الإدارة الأميركية في مواجهة الكونغرس حول السياسة الخارجية ولهذا السبب فإن المصريين أكثر صبرا.
أما الدول العربية التي لديها أدنى حد من الاتصالات مع الولايات المتحدة، فلديها شكوك تاريخية وشكوك جوهرية حول مدى استعداد الولايات المتحدة لمتابعة تسوية سلمية. وسوريا على سبيل المثال ترى أن المساعدات الأميركية لإسرائيل هي لتعزيز قدرات إسرائيل المعارضة للانسحاب من الأراضي العربية وتعتقد أن الإدارة ببساطة لا تريد تغيير الوضع الراهن في الشرق الأوسط.
وتوضح الوثيقة أن سياسات الولايات المتحدة في ما يتعلق بمشاكل الطاقة والقضية الفلسطينية وزيادة تدخل الكونغرس في السياسة الخارجية أثرت على أصدقاء الولايات المتحدة التقليديين في المنطقة.. فالمملكة العربية السعودية على سبيل المثال لديها تشاؤم متزايد حيال استعداد الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق سلام، ويشعر القادة السعوديون بالانزعاج حول ما يرونه تحديا أكثر من الرغبة في التعاون معهم لكنهم يدركون الفوائد التي تعود عليهم بسبب العلاقة مع واشنطن لكن التطورات الأخيرة في الولايات المتحدة أثارت تساؤلات حول قيمة استمرار الاعتماد الكبير على الولايات المتحدة.
وتضيف الوثيقة أنه على الرغم من تراجع النظرة السلبية للولايات المتحدة لدى الدول العربية في السنوات الأخيرة، فإن العلاقات العربية لا تزال هشة وعرضة للانقطاع، وتتأثر بقضايا مثل الصراع العربي – الإسرائيلي وترتكز على أسباب عاطفية أكثر منها موضوعية وعلى تقييم وجهة نظر القائد الشخصية في أداء الولايات المتحدة.
وقدمت الوثيقة تحليلا لكل دولة عربية على حدة، وتحت عنوان «مصر في حكم السادات»، قالت الوثيقة إن السياسات التي اتبعها السادات في السنوات الماضية تمثل مثالا صارخا للمرونة التي يظهرها العرب في الوصول إلى أهدافهم الاستراتيجية رغم الانتقادات التي يوجهها النقاد العرب للسادات في إخضاع المصالح المصرية لصالح الولايات المتحدة. صراع السادات مع الاتحاد السوفياتي يثبت مخاوفه من السيطرة الخارجية وشغفه (السادات) للحفاظ على استقلالية مصر (عدة سطور مشطوبة). لقد طور سياسة خارجية تستند على التعاون المشترك مع أي دولة يمكنها مساعدة مصر والولايات المتحدة تأتي على رأس القائمة. ويؤمن السادات وصرح بذلك مرارا أن الولايات المتحدة تملك كل أوراق اللعبة خلال جهوده للتوصل إلى تسوية تسمح بالانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة، وهو أهم هدف للعرب. واتجاه السادات لأميركا ليس سوى مجرد اعتراف بأن الولايات المتحدة يمكن أن تحقق هذا الهدف الذي من غير المحتمل أن يتحقق بقوة عربية عسكرية ولا بدبلوماسية سوفياتية. ويدرك السادات أيضا أنه لتحقيق هدف إعادة بناء مصر اقتصاديا فإن عليه أن يتجه إلى الاستثمارات والمساعدات التقنية الغربية بما في ذلك الولايات المتحدة.
وتمضي الوثيقة في الحديث عن علاقة السادات بالسوفيات وخيبة أمله الحادة في أن السوفيات لم يدفعوا باتجاه حل القضية الفلسطينية في عامي 1972 و1973، وتحتوي الفقرات التي تتحدث عن علاقة السادات بالسوفيات على العديد من الفقرات المشطوبة.
* سوريا تحت حكم حافظ الأسد
* تقول الوثيقة إن التناقض هو أفضل تعريف لنظرة سوريا السياسية وتوجهاتها تجاه الولايات المتحدة، ففي السنوات الخمس الأولى لحكم الرئيس حافظ الأسد جلب درجة من الاستقرار السياسي لسوريا وكان أكثر استقلالية عن البعثيين وأضفى تعديلات على سياساته الخارجية لتتماشى مع الواقع الدولي (وهناك أيضا عدد كبير من السطور المشطوبة حول سياسات الأسد الخارجية واختلافها عن سياسات حزب البعث). وقد تأسس حزب البعث عام 1940 مع ثلاثة أهداف هي التحرر من السيطرة الأجنبية والوحدة العربية والاشتراكية من أجل استعادة الشرف والهيبة، وهي أهداف ترتكز على كراهية الغرب واعتباره مسؤولا عن العجز السياسي العربي والتخلف الاقتصادي والاجتماعي. وهذه الأجواء من الشكوك هي التي تفسر الحذر الشديد في تعامل سوريا مع الولايات المتحدة وعدم استعدادها لقبول أفكار خارجية. والسوريون لديهم كرامة مرتفعة وخبرتهم مع الغرب خلقت لديهم عقدة نقص، فهم يخافون من الإهانة ويترددون في التسويات ويأخذون أفكار الآخرين بتردد وتشكك. والقادة السوريون لا يقدرون وجهات نظر الولايات المتحدة حول الشرق الأوسط ولا يثقون فيها. وكان القادة السوريون على استعداد لتكوين علاقات أفضل مع الولايات المتحدة عندما رأوا أدلة أن الولايات المتحدة تستطيع أن تحقق اتفاق تسوية حول مرتفعات الجولان، والآن عندما بدا أن إمكانات التوصل لاتفاقية ثانية أقل احتمالا أصبح السوريون أقل قابلية للتفاوض وينظرون لأميركا بشك.
* الفلسطينيون
* لا يمكن تصنيف الفلسطينيين في إطار واحد لاختلاف آرائهم السياسية وتوجهاتهم تجاه الولايات المتحدة، فهم يمثلون نسخة مصغرة من العالم العربي المنقسم وغير القادر على الاتفاق على استراتيجية واحدة وغير راغبين في اتباع إرشادات قائد واحد ويتباينون في درجة البراغماتية والتوجه حول الولايات المتحدة، والجماعات الفلسطينية المختلفة غير قادرة على صياغة سياسة موحدة تجاه الولايات المتحدة. ومنظمة التحرير الفلسطينية – التي تعد حجر الزاوية في الصراع العربي/ الإسرائيلي – انتهجت سياسة براغماتية مع الدول العربية تعتمد على تحقيق مصالحها الخاصة ووقوع الفلسطينيين تحت رحمة عرب آخرين جعلهم أكثر مهارة في ممارسة لعبة الأخذ والعطاء من بقية العرب. وتسببت الخلافات الداخلية بين الفلسطينيين وانقسامهم واختلافهم في فكرة التفاوض مع إسرائيل أقل تفضيلا لدى الولايات المتحدة، ومثل سوريا فإن منظمة التحرير الفلسطينية تتشكك بشكل عميق في الولايات المتحدة وتتردد حيال أي مبادرة تحتوي على فرص للتسوية. ويعتقد قادة منظمة التحرير الفلسطينية أن عليهم الحصول على تنازلات من الولايات المتحدة أولا قبل أن يقدموا على تقديم تنازلات من جانبهم. ورغم تشكك الفلسطينيين في الولايات المتحدة فإن قادة المنظمة يدركون أن مفتاح التسوية في الشرق الأوسط في يد الولايات المتحدة ويتجاوبون بشكل إيجابي غير رسمي مع تصريحات الإدارة الأميركية في نوفمبر 1975 ويبدون استعدادهم للتعامل مع الولايات المتحدة.
* العراق
* تقول الوثيقة إن العراق يعد خليطا فريدا في البراغماتية الخاصة والصلابة الآيديولوجية، وعلاقة العراق بالولايات المتحدة هي خليط من الانفتاح والشكوك العميقة، ففي المجال الاقتصادي دفع النفط وواقع الأسواق القادة العراقيين للتعامل بدرجة من البراغماتية. وأولوية العراق هي تحقيق تنمية اقتصادية ولذا يعتقد القادة العراقيون أنه يتطلب علاقات تجارية جيدة مع الولايات المتحدة. في عام 1974 أصبح العراق خامس أكبر سوق عربية للبضائع الأميركية (بعد السعودية ومصر والجزائر ولبنان) ويفضل العراقيون البضائع والتكنولوجيا الأميركية أكثر من بضائع أوروبا والاتحاد السوفياتي. وقد أعلن رجل العراق القوي صدام حسين اعتناقه لفكرة توسيع العلاقات التجارية مع الشركات الأميركية. لكن في المجال السياسي فإن العراق لديه جمود في علاقته مع الولايات المتحدة، ورغم الصفقات التجارية بين العراق والولايات المتحدة فإن بغداد تحتفظ بنظرة كراهية للغرب ويشكل ذلك نظرة العراق المتشككة للولايات المتحدة، ويبدي القادة العراقيون تشككا كبيرا تجاه تعاون الولايات المتحدة مع إيران وموقف الولايات المتحدة من الصراع العربي – الإسرائيلي. ولا يشكل ذلك رفضا أعمى من العراق لإقامة علاقات سياسية لكنه قرار متعمد واعتقاد بأن تحقيق مصلحة العراق يكون أفضل بالإبقاء على علاقات سياسية متباعدة عن الولايات المتحدة، ولا يرى العراق في الوقت الحالي أي مزايا للتحرك قدما نحو علاقات متقاربة.
* إسرائيل
* وتحت عنوان «إسرائيل والالتزامات الأميركية»، تقول الوثيقة إن العرب ينظرون للولايات المتحدة على أنها تملك مفاتيح حل قضية الصراع العربي – الإسرائيلي، ويؤمنون أن لدى الولايات المتحدة القوة للتأثير الكامل وإجبار إسرائيل على الانسحاب من الأراضي المحتلة، ويرون أن مصلحة الولايات المتحدة ستكون أفضل بعلاقات أقرب مع العرب أكثر من إسرائيل. والقادة القريبون من الولايات المتحدة أكثر تسامحا في رؤيتهم لعلاقة الولايات المتحدة بإسرائيل. وتختلف رؤية العرب لمدى التزام الولايات المتحدة بتنفيذ تعهداتها وفقا لدرجة تفهمهم للعملية السياسية الأميركية، ومعظم القادة العرب لا يفهمون استقلالية الكونغرس عن الإدارة ويعتقدون أن الإدارة غير مخلصة في ما تتعهد به.
وفي وثيقة بتاريخ 13 أغسطس 1978 رصد لردود الفعل العربية تجاه الوجود العسكري الأميركي في المنطقة، وتقول إنه منذ الثورة المصرية في عام 1952 أصبح وجود أي قوات أجنبية في الدول العربية لعنة تطارد معظم الدول العربية، ومع إغلاق مرفق الاتصالات الأميركي في المغرب والإجراءات التجميلية للقاعدة الأميركية في البحرين لتصبح مرفقا ميدانيا، فإن الوجود العسكري الأميركي المستقل لم يعد موجودا في العالم العربي وأصبحت اتجاهات مثل «عدم الانحياز» و«الحياد الإيجابي» و«العالم الثالث» و«مناهضة الاستعمار»، هي المصطلحات المسيطرة على هيكل السياسة العربية الحديثة، والجوهر الأساسي في جميع تلك المصطلحات هو التحرر من تحالفات عسكرية غير عربية.
وتقول الوثيقة إن أي دولة عربية تسمح بإنشاء قاعدة أميركية على أراضيها ستواجه بسلسلة من الدعاية السياسية السلبية التي لن تقبلها أي دولة. وهناك بطبيعة الحال وجود أميركي لكنه أقل من قاعدة عسكرية، ويشمل وحدات من المقاتلين في مناطق منزوعة السلاح، أو كجزء من قوة متعددة الجنسيات، ومن المرجح أن ينظر إليها باعتبارها حامية لإسرائيل وليست قوة محايدة لحفظ السلام.
المصدر: صحيفة الشرق الأوسط

